الفكر التقدمي: عود على بدء
الدكتور يحيى خميس
8 يوليو 2016
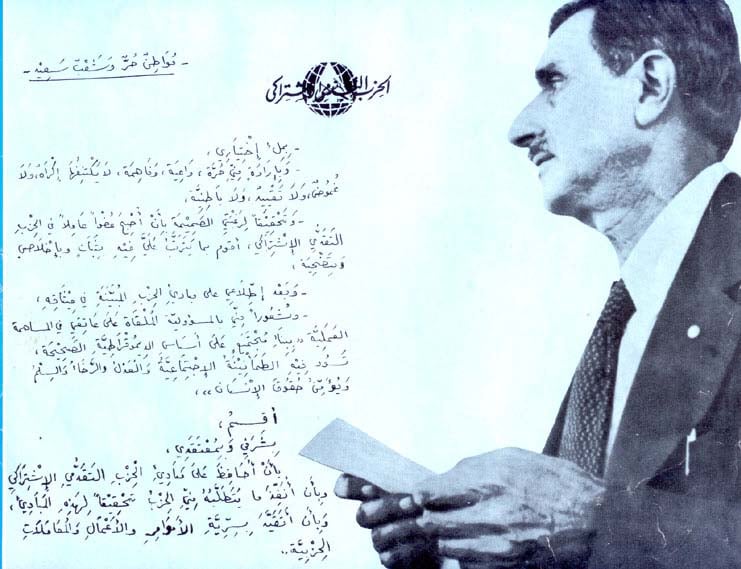
ليست هذه الدراسة بحثاً فلسفياً أو أطروحة أكاديمية، بل هي أقرب ما تكون إلى محاولة جديدة لإعادة طرح أحد الجوانب المهمة في الفكر التقدمي الإشتراكي، والهدف الرئيسي منها الإقتراب الموضوعي لفهم التقدمية، في مقاربة، لن نقول عنها تبسيطية، حيث لا يمكن التبسيط في أمور فكرية شبيهة، بل قد تكون محاولة لشرح تحليلي جامع، في سياق إنسيابي متصاعد وفي الآن ذاته متكامل، آملين عدم الوقوع في خطأ ما يصفه البعض أحياناً محاولة تجسيد الأفكار ليجدوا أنفسهم والقارىء أمام تشويه أو تحريف أو تحوير أو تفتيت للمبدأ، أو في الوقت عينه في خطيئة الجمود والتحجر التي يقع فيها أتباع المفكرين أحياناً الأمر الذي دفع كارل ماركس لأن يعلن يوماً: “أنني الوحيد الذي لست ماركسياً”.
أو كما قال كمال جنبلاط نفسه: “وكم من تحقيق يبتعد عن الأصل، وكم من تقليد يضيع فيه هذا التحقيق ذاته”.
فالتقدمية الإشتراكية هي نظرة شاملة للوجود، للكون، للإنسان و”للحياة على إطلاقها”، وليست فقط مجموعة من المبادىء التي استقاها كمال جنبلاط من مطالعاته ودراساته وأبحاثه في الفكر البشري، الضارب بعيداً في الزمان والمنتشر متسعاً في المكان، وصياغتها في عقيدة فلسفية جامدة، داعياً لتطبيقها بالمطلق دون أخذ الواقع بالإعتبار، بل هي إلى ذلك صفوة ما توصل إليه الفكر البشري بالإضافة إلى الإختبار التاريخي للبشرية وكل ذلك على ضوء العلم والواقع …
فما هي المعالم الأساسية للتقدمية في مفهوم كمال جنبلاط ؟
لو سألنا أياً من البشر: هل أنت تقدمي؟ لجاء الجواب فوراً ودون تردد نعم، وهل يمكن أن أكون إلا تقدمياً؟ وهل يرضى أحد أن يعطي لنفسه صفة الرجعية أو التأخر عن ركب التقدم والرقي؟
فهل كان معنى التقدمية التي أرادها كمال جنبلاط هو فقط نقيض الرجعية والتخلف؟ وهل أن التقدم الذي عناه هو فقط السير مع الزمن إلى الأمام والتبني التلقائي لكل جديد في مواجهة القديم؟
وهل هذا فعلاً كان قصد كمال جنبلاط عندما اختار لفكره ـ التقدمية ولحزبه اسم التقدمي الإشتراكي؟
ما أبسط الشرح لو كان هذا صحيحاً. أو فلنقل أننا لن نحتاج عندئذٍ إلى شرح ودراسات!
فالذهنية التقدمية التي نعنيها هي ذهنية التطور بمفهومه الحياتي الشامل العميق، الذي هو تطور الحياة ذاتها على وجه الأرض والإنسان أحد تجلياتها، لا بالمفهوم العادي للكلمة الذي يعني فقط المرور من حال إلى حال والعبور من طور إلى طور، من ضمن حياتنا القصيرة العابرة، ” فليس كل سير وكل اندفاع في الزمان هو تقدم“.
“فبعضنا يتصور خطأً أن ذهنية التطور تفرض عليه أن يتبنى كل جديد ويسير في ركبه، ويسمي هذا تقدماً وتقدمية، وأن يتنكر لكل ماضٍ أو واقع قائم، ويسمى ذلك رجعية وتخلفا“.
التقدمية التي نعنيها تتبنى فكرة التطور البشري، تطور البشرية نحو الأنظمة والأهداف التي عليها أن تبلغها، هو تطور الإنسان والإنسانية فينا نحو غاياتها الأخيرة… ولولا هذه الإنسانية، وقيمها المتظهرة فينا لما كانت هناك أية قيمة للأنظمة وللسياسة وللإقتصاد وللإجتماع، ولما استحقت أن نعمل لأجلها ولأجل بلوغها ساعة… فالأنظمة كلها تبقى ميتة وكلمات جوفاء إن لم تكن في خدمة الإنسان.
“التقدمية الإشتراكية هي في جوهرها تأليف جامع لعدد من التيارات الفلسفية، في المعنى الواسع، التي برزت في العالم، ونعني بذلك التفكير الإقتصادي والإجتماعي والنظري الفلسفي على حد سواء، أي المحاولة التفسيرية لمختلف نشاطات الحياة”.
وفكرة الحزب جاءت تأليفاً جامعاً لمعظم الحركات المعتقدية السياسية والاجتماعية التي “خضت مصير الكون وفعلت في التاريخ”.
وهو يمثل “النهضة الجديدة السليمة الجامعة لمقومات المادة والروح ولتراث الشرق والغرب، ولما استوعبته عقولنا من أنظمة واختبارات شعبية حية“.
كما أن الحزب يعلن في ميثاقه أنه تقدمي كونه “يتبنى نتاج العلم والتطور ومستتبعاته العملية في جميع الحقول”.
مما لا شك فيه أن صعوبة كبرى تقف أمام طرح موضوع التطور بكل نواحيه المادية والبيولوجية والإجتماعية والنفسية، وبكل أبعاده المعنوية الحضارية والإقتصادية، حيث تتواجه الأسطورة مع العقل، والخرافة مع العلم، والمسلمات المعتقدية مع ضرورة الإختبار العرفاني، وحيث يصطدم المرء بالتابوات على مختلف أنواعها. وفي عجالة يفرضها هذا النوع من الدراسات تزداد الصعوبة في أداء الرسالة، الهادفة إلى تقديم الصورة الواضحة والنظرة الجلية ضمن المحافظة على مبدأ الموضوعية والعلمية والإيجاز في الوقت نفسه، وضمن إلتزام بإحترام المعتقدات الدينية الموروثة حول نظريات التكوين والخلق وعدم الدخول في مناقشتها.
فماذا يعني التطور؟ وكيف لنا أن نفهمه؟
يقول كمال جنبلاط: “التطور هو ظهور كل باطن من الأشياء والكائنات وفيها، في الزمان والمكان المعد والمحدد لظهوره.. والتطور لا ينطلق من العدم، ومن العدم لا يخرج سوى العدم. وهو يخضع لقانون السببية، الشريعة الذهبية للكينونة المادية ولنبضات الحياة ونمو هياكلها وتطورها، هذه القاعدة السببية أي ما من علة بدون معلول وما من سبب بدون مسبب، هي موجودة وقائمة في كل شيء”.
وفي النهاية، في آخر مطاف الفكر، وتفتيشه عن السبب المادي ذاته وتقصيه لما وراء الظواهر الكثيفة ذاتها، وتدرجه واستعلائه المتصل في الإستقصاء إلى النقطة الهندسية (نقطة الدائرة من البيكار التي تصنع جميع الدوائر)، “لا بد للبحاثة المتجرد أن يرى اللطيف يبرز ويغلف الكثيف المادي من كل جانب” …
هذه النقطة الهندسية الأصلية الجوهرية والتي كانت في أصل فكر الحكماء القدامى، في الصين والهند والشرق كما في بنات فكر فلاسفة العقل اليوناني، هذه النقطة عاد إليها العلم الحديث في القرن الماضي في نظرية شهيرة في علم المجرات والأجرام والأفلاك تتضمن تصوراً علمياً ـ عملياً لبدء التكوين والإنبثاق، والخلق والعودة، في شكل ذرة أولى أساسية صغيرة جداً تجمعت فيها طاقات الوجود المعروفl’atome primordial وهو أمر ليس بعجيب، حيث أن هذه الذرات المتناهية في الصغر لو ضغطت كي لا يعود بينها فراغ ملموس لملأت حجماً يقارب قمع الخياط. وبهذا “تبدو لنا لطافـة ما يتكون منه الكون، الظاهر على غير حقيقته لعيوننا ولمسنا وحواسنا الأخرى “.
من هذه الذرة الأساسية الأولى التي تجمعت فيها طاقة جميع الذرات أي طاقة الكون بأسره، إنطلق، في ميعاد معين، تمدد هائل وانفجار في جميع الاتجاهات إلى حدود العالم اللامتناهي والمحدود في آن واحد، في ما سمي “بنظرية الإنفجار الكبير”.
عند هذا التفسير، يلتقي العلم الحديث والحكمة القديمة مع الاختبار الإنساني الشامل والذي هو في النهاية واحد، فإذا “تطلع الإنسان بعقله إلى الأفلاك الدائرة في سدم اللانهاية أو تفحص وتقصى انبثاق أجزاء الذرات من الفراغ المليء الأخير ومن الطاقة التي هي وراء هذه الأجزاء، حيث لم يعد هنالك حدود بين المادة والطاقة: فالطاقة تتحول على الدوام إلى مادة أي تتكثف فيها، والمادة تستحيل إلى طاقة أي تتلطف فيها لتزول في حقل ألإدراك الحسي للمس والسمع والبصر وتبقى في مجال الإدراك العقلي ـ العرفاني“.
هذه الطاقة الدفينة في أعماق كل وجود ـ ووجودنا لا ينفصل عن الوجود الكلي ـ تتكثف في مجرى الظهور والتحقق وفي تنزله… تماماً كما أن شجرة السنديان مثلاً كانت منطوية، مغلفة، مستبطنة، أي متصورة بشكل لطيف في البذرة التي أنبتتها، كذلك كل ما يبدو من واقع التطور فينا وبواسطتنا، يكمن في أعماق كياننا الفردي والسلالي والوراثي والحياتي العام. ولا يمكن مثلاً لبذرة السنديانة أن تنبت الصرو أو التفاح. فالتطور ليس شيئاً يأتي من الخارج، بل هو ظهور ما حوته الطاقة الحية فينا وما هو مستبطن ومغلف ومطوي في لطافة البذرة أو الصورة فينا “فلا تطور ممكن بدون استبطان لمكنات الطاقة. فالتطور عملية نشر لانطواء باطن دفين”.
فيجب أن نتنبّه دائماً وأبداً في مثل هذه الأبحاث أن لكلمة المادة المستعملة عادياً معنيين: معنى بوصفه مصدر الوجود ومجلى حدوثه السرمدي أي المادة “الهيولانية” قبل أن توجد المادة بأشكالها وصورها، ومعنى آخر بوصفه الحسي الذي يلمس ويدرك ونتصوره من خلال أشكال تحقيقاته المتنوعة بأنه كثافة معينة، بأنه مادة متشكلة متصورة.
وهذا الباطن من الأشياء، هذا المرتكز الورائي له، هذا الجوهر اللطيف هذه الهوية أو الهيولي Substance على حد تعبير أرسطو لا يتجزأ ولا ينشطر إلى هويات أو جواهر متنوعة، بل هو واحد متألق، نور بذاته، “ووعي أصيل لا نستوعبه ولا نتوحد فيه ولا نستوضحه على حقيقته إلا عندما نضع أنفسنا في مجراه وفي ينبوعه“. والإنسان ذاته كما يبرز أليس هو أيضاً جزءاً من هذا العالم الحسي؟ أوليس هذا الوعي هو جوهر كينونتنا الباطنة الأساسية؟.
فكمال جنبلاط يأخذ بفكرة التطور في مدلولها العلمي البيولوجي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي كما تبرز من خلال كبار الباحثين والعلماء والفلاسفة أمثال هكسلي وبرغسون وجاغاديس وشاندرا بوز وبخاصة الأب تيلارد دي شاردان وأروبندا وغوز… وفلسفة هيغل وماركس وانجلز وغيرهم من أرباب الفكر والعلم والتجربة الانسانية الغنية منذ أقدم عصور العقل البشري.
إن الحزب التقدمي الاشتراكي يتنكر لكل نظرة أحادية الجانب إلى الوجود على عكس الكثيرين من الفلاسفة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى فهم حقيقي لجوهر الإنسان والوجود نتيجة تبنيهم لمبدأ الأحادية في أصل التكوين.
إن نظرة التطور التي يتبناها الحزب “لا تنفي الروح لتؤكد المادة ولا تنفي المادة لتؤكد الروح”، في هذا التناقض الذي كان ولا يزال سبباً لفشل معظم فلاسفة الغرب، بل هي تعتبر الواقع كما هو عليه، أي “أن الإنسان واحد في جميع نشاطاته والحياة واحدة في جميع مظاهرها، والوجود واحد لا يتجزأ في جميع تحققاته”. وإذا كانت التجزئة ضرورية لأجل التحليل وتمكين الفهم من استيعاب العناصر البسيطة الأولى للمركبات، فيجب أن نتذكر بأن هذه الجزئيات لا توجد ولا تقوم إلا ضمن المركبات وفي حركة حياتها الداخلية وتطورها ـ فكل شيء في الوجود حركة وتبدل وتطور ـ وإن المركبات هي على الدوام شيء أكثر وأزود من مجموع العناصر التي تكونها وتدخل في تركيبها…
وفي هذا يقول الفيلسوف اليوناني طاليس: “الأشياء حية لأنها متحركة فالحركة روح الأشياء، وهي متغلغلة في الكون بكليته”. وبعده يأتي أرسطو ليؤكد بأن “لا وجود للعدم وكل شيء مقرون بالحركة، فالحركة لها سببها وهي أزلية“.
ثم يتابع الفيلسوف فريديرك إنجلز في كتابه دياليكتيك الطبيعة هذه الفكرة فيقول “توجب على علم الطبيعة الحديث أن يستعيد من الفلسفة القديمة مبدأ عدم هلاك الحركة وإلا لما كان بإمكان العلم الحديث أن يوجد.. ولكن حركة المادة ليست فقط الحركة الكثيفة الميكانيكية، أي إنتقال الشيء من مكان إلى مكان آخر، ولكن الحركة هي أيضاً الحرارة والنور، والتوتر الكهربائي والمغناطيسي والتركيب الكيميائي وإنفصاله وهي الحياة وأخيراً الوعي” أي اليقظة. وفي السياق ذاته يقول كمال جنبلاط: “في الحقيقة لا يوجد تناقض جوهري قائم بين الروح أو الفكرة وبين المادة. فكلاهما وجه من وجوه الظاهر بالذات، وكلاهما موضع حركة ومظهر حركة، وكلاهما يتكاملان ويتلازمان وينطلقان من وحدة وتصميم التكوين الفريد بذاته“.
في الواقع إن المادة والروح هما مفهومان فكريان ووجهان للحقيقة التفسيرية الأخيرة الشاملة في نظرتها وتفسيرها الكلي، المادة والروح. فالحقيقة الأخيرة يجب أن تتعدى مظاهر المادة والروح ويجب أن تكون واحدة.
أما الحياة فهي طاقة الوجود المترفعة والأسمى في مسار التطور”هي مظهر الوجود، هي طاقة الوجود الأخيرة، وهي قابلة للتحول فينا إلى طاقات معنوية وروحية واجتماعية تماماً كما يتحول التيار الكهربائي المادي في السلك النحاسـي إلى دفء حرارة وإشعاع نـور وحركة “.
ومن خصائص طاقات الحياة أنها تولد كائنات قابلة بحد ذاتها للنمو “طاقة خلق حياة جديدة هي الأساس فينا وليس الأساس هو فرديتنا وجسدنا وشخصنا، لأنها قوة خالدة فينا تصل بداية الكون بآخره، وتربط بين شطآن الوجود أولها بآخرها“.
فلكل كائن حي القدرة على أن يعطي كائناً حياً آخر، لأن الخلية الأصلية عند ذوات الخلية الواحدة وفي الخلايا الوراثية للإنسان، في مسيرة الانقسام والاستمرار، هي دائماً تشبه الأصل ولا تقبل الموت. وفي معراج التطور تتجمع الخلايا في تركيب أعلى وتقوم كل مجموعة منها بوظيفة معينة، فتكون الحيوانات ذوات الخلايا المتعددة والحيوانات العليا وتبرز الأعضاء التناسلية، تموت بقايا خلايا الجسد على التوالي أو عند حدوث الموت، بينما يتوارث الإنسان الخلية الوراثية المنقسمة على ذاتها فتنتقل هذه الخلية من الأب أو الأم إلى الطفل، وهكذا إلى ما لا نهاية.
ويظن الكسيس كاريل (صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول) إنه عندما ترتقي الحياة إلى مستوى الكائن المتعدد الخلايا يبرز تدريجياً ويتصاعد مظهر نفساني جديد من مظاهر التطور وكأنه تعويض عن ديمومة تلك الخلايا الأولى البانية: هو الشخصية البشرية.” فالشخصية في الإنسان وتمتعه بها قد تكون تعويضاً للفرد عن ظاهرة موته” على حد تعبير د. خليل احمد خليل.
و”الإنسان وليد ما تجمع وتراكم في أغشيته وخلايا أعصابه ودماغه وما استبطنته محاور غرائزه ونزعاته، من هذه الأحقاب المتعاقبة والمؤلفة من عشرات الآلاف وملايين السنين، التي دفع فيها التطور الحياة من المادة الحية البرتوبلاسمية الأولى، في البحار الدافئة التي كانت تضيئها وتسقيها الأشعة الليلكية وما بعد الليلكيةViolet ou ultraviolet ، وتقدمها باستمرار الأشعة الكونية والهادمة والبانية على الدوام، وتحضنها بوتيرتها الانفجارات المترادفة للمواد الذرية المشعة الأولى، إلى أن برز الإنسان الأول على وجه البسيطة “.
“وعلينا أن لا ننسى ذلك على الإطلاق: إننا وحدة لا تتجزأ من صميم هذه الأرض، التي ارتفعت فوقها قشرة الحياة في أوج اعتلاء تبلور الطاقة الكونية وترفعها وتوقها إلى وعي وجودها والاستشعار بدفء السعادة وطراوة الحياة”، وكأني بكمال جنبلاط هنا يستذكر ويتوافق مع إنجلس بأن الطبيعة مع هذا الكائن الفقري ـ الإنسان توصلت إلى وعي ذاتها.
اتجاه التطور الأول : الوعي والحرية
“التطور هو مجرى الخلق ذاته ومعراجه فينا ” وهو مفتاح السر لكل ترفع حقيقي ولكل حياة نريدها عزيزة عامرة ومرتبطة بحياة الكون ومصيره. لقد تحرر الإنسان من ثقل الغريزة وتوجيهها عندما برز من الحيوانية . وإذا كان التطور المادي ـ النباتي ـ الحيواني الذي اختار عبره الوجود التعقيد والارتقاء من الناحية الخلوية البيولوجية ليصل إلى أرقى وأسمى مخلوقاته في المملكة النباتية الحيوانية وآخر أنواعها الإنسان،” فإن العلوم البيولوجية، وما تفرضه من استنتاجات تظهر لنا الحياة كأنها تنزع عن قصد أو غير قصد ـ في أحد اتجاهاتها الكبرى ـ إلى الزيادة المطردة في مقدار وعي الكائن الحي، وحدة هذا الوعي، وإلى الزيادة في حريته وطاقته في التصرف من خلال قيود المادة وسننها كلما ارتقى في سلم الأجناس والفصائل والفروع التي تتطور باتجاه الدوحة الحيوانية التي يتوجها ويختمها الإنسان“.
ويظهر لنا كنتيجة لهذا الوعي ولهذه الحرية في الإنسان، أن التطور كأنه عدل عن نزعته البيولوجية الظاهرة، (تخلى عن إرادته في مزيد من التطور البيولوجي في خلق أجناس وأنواع جديدة) وعلى الأقل عن نزعته باتجاه الدوحة التي ختمها الكائن البشري، الرامية إلى التحقق والإمتداد والتنوع بأجناس وفروع وفصائل جديدة ـ وأن تطور الحياة قد تحول، بفضل هذا الوعي وهذه الحرية، إلى تطور إجتماعي وأخلاقي ونفسي، هدفه استنباط القيم وإنشاء الأنظمة الإجتماعية والأخلاقية والروحية، ولعل هذا هو الفاصل الوضعي بين عالم النبات والحيوان وعالم الإنسان.
“على ضوء هذا الإدراك، يتضح لنا خلال عملية التطور غرض الحياة منا وفينا وأننا أداة مكلفة في الواقع بتحويل التيار الحي، الزاخر بالإمكانيات منذ فجر الحياة، إلى فكر وشعور وإشراق وقيم حق ومحبة وجمال، ويتضح لنا أيضاً أية قيمة هي الشخصية البشرية، وأية قيمة هي حياة كل كائن بشري ورسالته، وذلك بالاستقلال التام عن أي مبدأ ميتافيزيقي ولاهوتي كان، لو استطعنا أن نقرر ذلك دون أن نستنير بالإختبارات الروحية الحية“.
فمع وصول التطور إلى أعلى مراتبه البيولوجية مع الإنسان ـ هذا التجلي الأخير للوجود الظاهر ـ فيما يتعدى كل ازدواجية أو ثنائية مادة وروح ـ أخذ التطور منحاه النوعي، إذا صح التعبير، من خلال زيادة مقدار الوعي والحرية عند الإنسان. وفي الحقيقة الحرية هي الوعي. هي تحديد آخر ووجه مماثل للوعي، ولا تكون حرية ولا تقدم بدون الوعي.” الوعي هو جوهر الوجود، هو اليقظة التي هي عين هذا الوجود، والتي بها نعاين الشاهد والمشهود“.
إن النظريات العقلانية التوحيدية للوجود التي تعتمد مبدأ التحول والتبدل على إطلاقه في عملية كل خلق وإبداع. (أي مبدأ الجدلية ..) وكذلك ارشادات العلوم الحديثة، كما مبادىء الفلسفات والمسالك الحكمية والعرفانية القديمة، تؤكد على وجود “كينونة” لا تتحول ولا تتبدل ولا تبدأ ولا تزول وراء الصيرورة الدائبة والتحول المستمر لصور المادة وأشكال الطاقة. “فلا يمكن ـ كما يرشدنا إلى ذلك العلم الحديث ـ إلا أن تتحول في نهاية الكشف والتحليل هذه الصور والكائنات المتبدلة إلى مادة هيولانية أو طاقة واحدة “.
ولو لم يكن فينا، أي في المدرك ـ العارف، الشاهد، عنصر عقلي ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول ـ أي بالتالي غير قابل للهلاك، (“وكل ما لا يتبدل ولا يتغير لا يمكن أن يهلك أو يزول أو ينعدم ـ لأن الزوال والهلاك والانعدام هو ذاته تبدل وتحول”) لو لم يكن فينا هذا العنصر العقلي الجوهري الثابت، لما استطعنا أن ندرك تيار التبدل والتحول حولنا. هذا العنصر الذي يبدو لنا أحياناً أنه يتغير إنما في الحقيقة تتغير معرفتنا للظواهر والأشياء والأحداث فنظن أنه هو الذي تغير بينما في الحقيقة هو الثابت الذي يساعدنا على فهم إدراك حقيقة تلك الظواهر والكائنات والأحداث والأشياء.
هذا العنصر الجوهري لوجودنا، هو الذي يسميه كمال جنبلاط على لغة تيلار دي شاردان وعلى لغة الأقدمين أيضاً الوعي Consciousnessأي التنبه، اليقظة، المعرفة المحض. وهي التي يسمونها في بعض الكتب الدينية النور أو نور الأنوار.
يدعو كمال جنبلاط للعودة إلى “كانت” Kant الذي تتوافق نظرته مع استنتاجات العلم الحديث: “إن كل ما نعلمه من الواقع الخارجي، ومن جسدنا أيضاً ، نعرفه بواسطة الحواس: البصر والسمع والشم والحس والذوق. أما الأشياء كما هي بحد ذاتها، في حقيقتها فلا يمكننا أن نعرفها إلا بواسطة الإدراك الحسي المباشر حيث يبرز دور الفكر وكأنه حاسة سادسة، على حد تعبير شنكارا تشاريا، لينقل الصور الحسية إلى صور فكرية Images mentales على حد تعبير أدينغتون Eddington وجينز Geans وراسل Rassel وأينشتاين Einstein وهايزنبرغ Heisenbrg وسواهم من كبار العلماء”. ولا نستطيع أن نعرف من الوجود الظاهر سوى هذه الصور الفكرية، فهي نظراً للطافتها، تنسكب في المعرفة وتزول في الوعي، فالأشياء التي ندركها من العالم الخارجي ومن جسدنا ذاته ليست إلا رموزاًSymboles لا أكثر، تماماً كما هي عليه الكلمات التي نستخدمها للتعبير.
ولو لم تكن هذه الصور الحسية للأشياء ـ أي الأشياء ذاتها في النهاية والتي تتحول فوراً إلى صور فكرية ـ مصنوعة من المادة ذاتها التي صنع منها العقل ذاته لما تمكنت أن تنصهر فينا وأن نعرفها وهكذا تبرز وحدة الوجود الحي المطلق على حقيقتها “ولا يمكن أن ننطلق لأجل معرفتها إلا من عقلنا”.
وفي ذلك يصح القول المأثور: “تعـود الدائرة إلى نقطـة البيكار، وترجع اليـاء إلى ألفهـا (شاردان) أي إلى المصدر الذي منه انبثقت ازدواجية الدائرة والفسحة التي تحضنها. وتتوضح الكلمة المعروفة المنقوشة على عتبة هيكل دلف Delphes ” اعرف ذاتك“.
لقد أوضحنا، مع كمال جنبلاط اتجاهات التطور التي ارتقت في الحياة مع الإنسان، وأبرزنا اتجاه الحياة في تظهير الوعي والحرية الناميين في سلم ارتقاء الإنسان من الدوحة الحيوانية، وشددنا على أن تطور الحياة قد تحول بفضل هذا الوعي وهذه الحرية إلى تطور اجتماعي وأخلاقي ونفسي هدفه استنباط القيم وإنشاء الأنظمة الاجتماعية والأخلاقية والروحية ـ قيم الحياة قيم الوجود ذاته. وهذا ما يمكن أن نسميه مسار التطور الإنساني ـ الاجتماعي والذي نعبر عنه في الفكر التقدمي بتيار التجمع البشري والتكور الإنساني.
- الاتجاه الثاني للتطور: التجمع البشري:
يعتبر كمال جنبلاط أن التجمع البشري الذي يبدو، في منظارنا للوجود الحي بكامله، كمرحلة حتمية من بلوغ البشرية (هذه الفصيلة بين سائر فصائل الحياة) مرحلة الجمعية أو التجمع Socialisation، في ارتقائهـا إلى هذه الدرجة من نموه، السلالي و”نعني بذلك أن الكائن الحي، عندما تأتلف، في هيكله وأعضائه الخلايا وجماعات الخلايا على تشابكها، يعمد إلى التناسل، فإذا ما بلغ هذا التناسل حداً معيناً، ينزع الفرد إلى التجمع في وحدة عضوية مميزة “.
إن الإنسان لا يمكنه عملياً أن يولد وحيداً. فهو وليد المجتمع دائماً وأبداً ففي المجتمعات البشرية الأولى لم يكن يوجد جماعات مترابطة نظراً للوضع المتأخر الذي كانت تعيش فيه وتعتمد على صيد الحيوانات وقطف الثمار البرية، وتلك بداية العصور الأولى، ثم تطورت المجتمعات البشرية إلى عصر الزراعة الذي بدأت معه مرحلة جديدة من إتقان البشرية لزراعة الأرض واحتلالها لبعض المساحات، خاصة الصالح منها للزراعة، فتنتج نوعاً من العلاقات الاقتصادية التي تفرض ارتباطاً أقوى بين الجماعات، وارتباطاً مباشراً ثابتاً بالأرض فبرزت فكرة الجماعة والاستقرار والوطن البدائي.
وبمرور الزمن ومع اكتساب العقل الإنساني لإمكانية أكبر في حقل الإبداع والمهارات، وبسبب تراكم التراث والتعقيد البشري على مختلف مستوياته، وصلنا إلى فجر العصور الحديثة الذي يحدده علماء التاريخ باكتشاف أميركا… بيد ان المرحلة الحقيقية لهذا الفجر الجديد كانت مع اختراع الآلة الحديثة واستخدامها وخاصة مع الثورة الصناعية ومستتبعاتها وإختراع الطباعة التي أدت إلى انتشار الثقافة والعلوم ومكنت الرأي العام من الاطلاع وتبادل النظريات والآراء والمعارف عن طريق الصحافة والكتب، إلى أن نصل إلى بدايات القرن العشرين حيث أضيف إلى الاختراعات السابقة إختراع الكهرباء الذي مهد لمرحلة جديدة من مراحل تطوير الصناعة، وازدادت الروابط بين البشر وازداد العلم، فوصلنا إلى عصر مكننة الآلات وفق العلوم الحديثة وتطبيقها.
ثم جاءت مرحلة الاختراعات العلمية المتسارعة على شكل قفزات علمية ثورية مع اكتشاف واستخدام وسائل جديدة للطاقة وصولاً لانقسام الذرة واستخدام الطاقة الذرية… والاتصالات والمواصلات، وتطور علوم الهندسة الوراثية والجينوم البشري (جهاز المورثات) وغيرها من العلوم المتعلقة بالإنسان والمجتمع والطبيعة والحياة والكون والوجود…، ما أدى إلى تطوير العلاقات البشرية وتكثفها وزيادة حدة ارتباط الجماعات البشرية ووحدة وجودها ومصيرها كما وحدتها مع الطبيعة والمخاطر التي تواجهها.
هذا الاجتماع البشري يتعدل وتتعدل قواعده وظروفه وذهنيته لينسجم دوماً مع التبدل التقني الحاصل وكذلك مع أنظمة المجتمع الحقوقية والمعنوية أي مع مسيرة الحضارة والمدنية.
يحصل هذا والجماعة البشرية تزيد من ترابطها وتشابك علاقاتها وتجمعها. هذا التجمع البشري أو التكور الاجتماعيSocialisation هو ما تعني به التقدمية بالاتجاه الثاني للتطور. هذا التجمع البشري، المتكاتف على نفسه بساطة وتعقيداً على التوالي وفي آن واحد، ينزع إلى تمثيل وإظهار مطلب الوحدة في الإنسان وعكس هذا المطلب الأساسي في المجتمع والحضارة. هذا الاتجاه للتجمع البشري المتطور والخطير هو الذي يفرض في داخل المجتمع، (وقد تكون خطورته هي التي تفرض قبل أي شيء آخر) الاشتراكية الإنسانية التي طرحها كمال جنبلاط.
وهذا ما عنى به في ميثاق الحزب بأن البشرية وصلت إلى درجة من نموها السلالي يمكن أن نسميها بمرحلة الجمعية أو تجمع القوى والطاقات ومحاولة توحيد تنوعها المتشعب المتزايد في بوتقة المجتمع Socialisation Humaine وفي تآليف إجتماعية متطورة عما سبق أو مضى: “إن الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة ـ ومنها النزاعات القومية المتزايدة، وهذا الصراع العالمي على السيطرة وعلى النفوذ، وهذا الكفاح المرير بين الشعوب والفئات الاجتماعية المتخمة بالمال والغذاء وبحبوحة العيش وبين نصف سكان الأرض الذين يتضورون جوعاً… إن الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي تهز العالم اليوم تعني في الظاهر أن البشرية قد بلغت بدورها، السن التي تنزع فيها كل فصيلة، بضرورة بيولوجية، إلى انتظام وسجم أعضائها… ففينا يظهر أن البشرية تقترب من طور تجمعها أو تطورها الإجتماعي الخطير“.
وهذا التجمع البشري يفرض النظام لحل مشاكل الإقتصاد والمجتمع، لا الفوضى، أي الحرية المطلقة الظاهرة، بل الحرية المرتبطة بالوعي والتي تشكل الوجه الآخر له، يفرض وجود نظام للأخلاق والمناقبية للإنسان ولعلاقاته مع الآخرين ـ فالنظامان كما يقول كمال جنبلاط “… نظام المجتمع ونظام الأخلاق متلازمان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر، وإلا سقط الفرد وفسد المجتمع واضمحلت الحضارة، وتبعتها في اضمحلالها جميع مكاسبها المادية، وهذا النظام المطلوب هو النظام التقدمي الإشتراكي الإنساني”.
هذا التجمع البشري، هو الذي تبرز منه، خارج نطاق الشعب والدولة، حركة الإلتقاء الكبرى للقوميات الواسعة، وأنظمة وروحية التعاون والإتحاد في إطار بعض الحضارات والقارات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا على السواء، (الإتحاد الأوروبي، تجمع دول شرق آسيا، المؤتمر الأفريقي والسعي لقيام الوحدة الأفريقية، التجمعات الإقتصادية المتعددة في مختلف أنحاء العالم…)
هذا التجمع قد يتخذ أشكالاً متنوعة وصوراً متباينة، وفق الشعوب والظروف، وواقع النزاعات والأهداف، (وهذا ما رأيناه من خلال الأمثلة) لكنه تيار حتمي يشكل إنعكاساً لنداء الحياة الطبيعي في الإنسان التائق إلى الحقيقة في الوحدة والتوحيد.
* الاتجاه الثالث للتطور : التكور الإنساني
إن تيار التجمع البشري الذي حددناه سابقاً يفعل فعله داخل المجتمع الواحد ليزيد عمق العلاقات وتشابكها بين البشر، وفي الوقت نفسه يزيد من قوة وكثافة وعمق علاقات الناس فيما بينهم في الخارج، أي بين الشعوب والأمم، وهذه النزعة البشرية للوحدة والتجمع تتجلى من خلال ما يسميه كمال جنبلاط بتيار التطور الثالث أو التكور الإنساني والذي يعتبره مظهراً لوحدة الإنسانية Planétisation ” والتحسس أكثر فأكثر بوحدة هذا السيار الذي نعيش عليه “. وهذه ” الوجهة الموحدة للعنصر البشري وللكون بات يتحسس بها، كأخوة جامعة وفاهمة، جماعة من الناس يتزايد عددها أكثر فأكثر، جماعة الإنسان التطوري “l’homme évolutionniste.
من هذا المنطلق، تطرح التقدمية فهماً آخراً للقومية بعيداً عن بعض مظاهرها التي عرفتها الأزمنة البدائية القديمة، وكذلك عن التفسير الماركسي، وعن الفهم الفاشي والنازي الذي انتشر مع بعض علماء الاجتماع الأوروبيين وانتقل تأثيره إلى مجتمعات أخرى ومنها لبنان. “فكلمة القومية ذاتها بمدلولها الحاضر هي غير موجودة في قواميس اللغة العربية، وأنها ابتكرت لهذا المعنى في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً”. إن مفهوم القومية التي نريدها ينسجم إنسجاماً تاماً مع الاتجاهات الكبرى للتطور، حيث لا تكون القومية أداة عزلة وإنغلاق وتقوقع أو “قطباً مثيراً دائماً على نفسه، محتجباً ومنزوياً في أنانية ذاته”، بل هي وسيلة من وسائل التقاء البشر وانفتاحهم على هوياتهم وماهياتهم وثقافاتهم وحضاراتهم، للإنسجام والتفاعل والاسهام في عيش الجماعات كلها القاطنة كوكب الأرض الصغيرة.
تلك القومية تتنكر لكل فكرة تقوم على القوة واستثارة كبرياء الفرد والجماعة، والعصبية العرقية أو الثقافية، ونزعة الإنكماش والحقد والاتساع على حساب غيرها من الجماعات.
إن الصراعات الكثيرة التي شهدتها البشرية والتي وصلت في السنوات الأخيرة إلى حد يهدد مصيرها ووجودها تتطلب من البشر جميعاً تلبية نداء التطور الطبيعي ومطلب الوحدة في نفوسنا.
إن فكرة المتحد القومي يجب أن تكون جسراً للعبور إلى التكور الإنساني الأشمل ضمن مبدأ التعددية والتنوع تماماً كما أن الإنتماء الوطني والمواطنية الحقيقية التي تعزز قيمة الإنسان المعنوية وتقوي دور الإنسان الشخصPersonne وليس الإنسان الفردIndividu وعندها يصبح إنتماؤه الأوسع إلى المتحد القومي خياراً حراً، واعياً نافعاً، فاعلاً فيدخل في رحابها وليس إلى سجنها.
“وفي الحقيقة، الفرد مجرد مكنة أو إمكانية، وهو إنسان بالقوة لا إنسان بالفعل، وهكذا فلا يكون للفرد في المعنى السليم الأكيد للحرية، إلا حق واحد وواجب واحد بأن يحيا وبأن يصبح ويصير إنساناً أي شخصاً تحققت فيه الإنسانية”.
التطــور والثــورة :
لقد سبق وأشرنا لدور الجدلية في مجرى التطور (والجدلية تتطلب دراسات وأبحاث طويلة ومفصلة) وللأسلوب الجدلي، للتناقض والتنافر والاستقطاب الذي هو أساس كل تكوين في جميع المستويات المادية والنفسية على حد سواء.
وهذه الجدلية للتناقضات تفترض وتتضمن تفاعل التناقضات المرتبطة ببعضها، وبوحدة الكينونة، فلا يقوم قطب منها دون انجذابه أو نفوره من القطب الآخر، وتتحقق نتائج هذا التفاعل عملياً إما بالتطور البطيء أو السريع أو بالثورة. تماماً كما يحصل في عالم النبات والحيوان فيما يسميه العلماء الطفرة Mutation، عند ولادة كائن جديد مختلف عن والديه أو نبات تختلف مواصفاته عن الصورة الكامنة في خلاياه الوراثية، ومع ما يرافق ذلك من أخطاء وتشوهات وانحرافات كانت تقع في مسار التطور الطبيعي نتيجة عوامل طبيعية مختلفة كتداخل العوامل واختلاف الظروف وعامل الصدفة… وزاد في حدتها ومخاطرها تدخل الإنسان في محاولاته العلمية وخاصة بعد التطورات البيولوجية المهمة واكتشاف DNA وشفرة الجينوم البشري والهندسة الوراثية وتطور كافة العلوم المساندة والمساعدة على سبر أغوار الأسرار الحياتية والبشرية…
وهكذا يحدث على مستوى الجماعات والتحولات المفاجئة التي تحصل لها، من ثورات وانقلابات وإبداع لأنظمة جديدة، “إلى أن يأتي وقت طبعاً تتعرض فيه السلالة وتهوي الحضارة وفق قاعدة أخرى تعتبر حياة الجماعات والفصائل والحضارات ذاتها، والأنظمة، كحياة الأفراد تماماً، تبدأ وتنمو وتزدهر وتنضج ثم تذوب وتشيخ وتنحل وتموت”. وفي رأي بعض العلماء، قد يكون الجنس البشري القائم على طريق انحلاله بما يصنعه لنفسه من أجواء وظروف ومتطلبات واختراعات وتطبيقات غير منضبطة ولا تتلاءم مع طبيعته وأغشيته وأعصابه ونفسيته وفرادته. وفي هذا المعنى نستذكر قولاً للدكتور محمد سعيد الحضار “إننا إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على أننا الجيل الذي رفع إنساناً إلى القمر …، بينما هو غائص إلى ركبتيه في الأوحال”.
أما ظروف التحول المفاجىء في الحقل الاجتماعي والسياسي، أي الثورة، فإنها تكمن في اشتداد حدة التناحر والتناقض في المجتمع، وبخاصة التناقض الاجتماعي والاقتصادي الذي يهم بشكل مباشر حياة المواطنين.وإذا حللنا بشكل موضوعي هذه النظرية، نجد أن السبب الرئيسي للثورات يعود إلى التفاوت بين الأنظمة والمؤسسات الحقوقية وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية النامية للجماعة. فأنظمة القرون الوسطى مثلاً، انهارت لأنها لم تعرف أن تتبدل وأن تتكيف بسرعة مع التبدل الذي طرأ على التقنية والاقتصاد والأفكار وفي هذا يقول لينين أن اللحظة الثورية التاريخية تأتي عندما لا يستطيع الحاكم أن يحكم كما سبق وحكم، وعندما لا يستطيع الشعب أن يعيش كما سبق وعاش.
إن التقدمية الاشتراكية هي مسلك ثوري دون شك وهذا المسلك الثوري نفسه هو مسلك علمي قبل كل شيء، “وعمل يتطلب مواجهة الإنسان الكلية، فينطلق من إرادته الواعية ثم يتشخص في تصور فكره وفي مشاعر قلبه، ثم يتحقق في تحريك عاطفي وعقلي لفئات من الجماعة، ولا يلبث هذا التحريك أن ينقلب عملاً مباشراً“، هذه القابلة التاريخية للوجود.
التقدميـة وآفاقهـا المستقبلية:
إن التكاتف الإقتصادي والسياسي والفكري والثقافي والمعنوي، وتداخل المشاكل الاقتصادية والتقنية والسياسية الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر والتي يصعب حلها إلا في نطاق واسع أو إقليمي أو عالمي تؤكد صحة ما ذهب إلية علماء الأنتروبولوجيا (علم الدراسات البشرية) والإجتماع في نظرتهم إلى وجهة العالم المقبل ونزعته إلى الإلتقاء والوحدة. ورغم بعض النزاعات الإنعزالية والمتقوقعة التي ما زلنا نلحظها في بعض المجتمعات، ومنها مجتمعنا نتيجة التراكم التاريخي لرواسب مختلفة اجتماعية وثقافية ودينية، رغم ذلك فإن نزعة التوحد تبقى الأقوى والأكثر فعلاً وتأثيراً على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي. حتى أن مفهوم السيادة الوطنية المعاصرة آخذ يختلف عما كان سائداً في الزمن القريب الغابر نتيجة وجود معايير جديدة للقانون الدولي والشرعية الدولية والعلاقات الدولية.
وفي معرض المراقبة لما يحصل، في بعض أنحاء العالم ومنها منطقتنا من عودة إلى الفوضى والتشتت والانقسام والعصبية والحقد والحروب يجوز التساؤل: ألا يعتبر ما يجري نقيضاً لمبدأ التطور وتيار التجمع الذي تحدثنا عنه؟
إن قراءة سريعة لما يجري في تلك المناطق من العالم، (حيث لا مجال في هذه الدراسة من الاسترسال في تحليلها ومناقشتها)، يؤكد أن السبب الأول في العودة الى البدائية وعدم السير في الركب الطبيعي للتطـور يرجع إلى فقـدان الأنظمـة الديمقراطيـة الحقيقيـة (السياسية والاجتماعية والاقصادية) ووجهيها الملازمين والمتلازمين: الحرية والمساواة (وهنا طبعاً نقصد المساواة العضوية التي يطرحها كمال جنبلاط بديلاً للمساواة الحسابية التي طرحتها الثورة الفرنسية في خطأ بشري جسيم).
ولأن في بعض الحقبات “يهتز رقاص التاريخ” وينحرف عن مجراه نتيجة إنحراف بعض الجماعات والقادة عن أوجه التطور الطبيعي الذي حددته التقدمية، فنرى مثلاً جنوناً للعظمة عند بعض القادة، وتعصباً عرقياً عند بعض الشعوب التي تعتبر نفسها مختارة، وعند بعض الجماعات التي تعتبر نفسها مخلوقات إلهية، أي باختصار شديد تلك التي انحرفت عن وجهة التطور الإنساني الحقيقي الذي يعتبر الإنسان واحداً أياً كان لونه أو عرقه أو دينه… ولأسباب كثيرة أخرى توسعية وإقتصادية (السيطرة على الطاقة والمواد الأولية وأسواق الاستهلاك…) وأحلام تاريخية تستيقظ بعض الأحيان لتهز العالم، لكن سرعان ما تخمد.
لكن الغلبة في النهاية ستكون لتيار التطور الحقيقي، ولا بد هنا من الإشارة إلى دور الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية والاعلام، والقوى الفاعلة لوعي وظيفتها الطبيعية في تصويب الاتجاهات وفي تحقيق ديمقراطية صحيحة من خلال إبراز نخبتها، إبراز الأفضل والأسلم والأقدر. وهذا هو قانون الطبيعة وهذا هو دور الحياة ذاتها الزاخرة فينا منذ ملايين السنين، والكامنة فينا في طاقات وراثية متكدسة متراكمة تراكم ألاف الأجيال.
وفي نظرة متفائلة إلى اكتمال دورة مصير التطور والتاريخ يرى كمال جنبلاط انه قد يحصل هذا التحقق “ويرتفع الإنسان من مرتبة الفكر إلى مرتبة العقل، بعد أن اعتلى من مرتبة الغريزة إلى مرتبة الفكر… وقد يحصل ذلك بعد محن وإختبارات مفجعة، ليست أقلها الحرب المحرقة الذرية التي يهيئون لها العدة والسلاح، وهي النتيجة الطبيعية لانقسام البشرية إلى مستثمِر ومستثمَر، وقطعان من المتخلفين والجياع بنسبة النصف إلى الثلثين من مجموع سكان الأرض، ومن مجتمعات متخمة مترفة، ونظراً لازدياد عدد البشر بشكل تصاعدي مريع، ولأن الفكر هو الذي لا يزال يتحكم بحياة الناس وصيرورتهم وعملهم وإيمانهم، لا العقل”. ولنقل أحياناً أن الغريزة تعود لتستيقظ وتتحكم مكان الفكر الذي ارتقت إليه.
ولأن ليست كل نزعة للتطور “تعتبر تطوراً في المعنى السليم للكلمة، أي تقدماً حقيقياً شاملاً لمفاهيم الإنسان المادية والمعنوية، ولأن التطور يحاول التجربة مراراً في محاولاته للظهور، قبل أن يجد الطريق الصواب والمنفذ الأفضل… وحيث أن التطور هو في النهاية امتداد لتفاعل عقل الإنسان بالوجود، فهو قابل كهذا العقل، للامتحان والتجربة والتحسين والتطوير” .
إن اتجاهات التطور الكبرى التي حددها كمال جنبلاط في سياق بحثه عن الحقيقة، لا تحمل معناها الحقيقي ولا تؤدي وظيفتها، إلا إذا أدركها الإنسان ووعاها وأدرك أنه جزء منها وهدفها ضمن وحدة الوجود والكون الكبرى، “وتوحد بمظهر هذه الحياة الكونية الأخير الذي هو عيش السلالة البشرية ونضالها وتطورها واستعلاؤها وقوتها ومصيرها“. فالإنسان جزء من هذا الكون ومظهره الشامل الأخير، ويبدو أن هذا الفهم الموحد للحياة والإنسان والوجود يتطلب هذا التوجه إلى الوعي، إلى الجوهر لنفهم أن لا تفريق ولا تمييز بين الكون ونحن وإن العمل المجرد عن الغاية الشخصية، وإن التضحية والعمل السليم المحب، الجريء، هو السبيل الأصح لذهنية الانفتاح للاقتراب إلى الآخر فهماً ومشاركة ومصيراً على طريق اتجاهات التطور الأخرى، أي التجمع البشري والتكور الإنساني.
فالعودة دوماً وأبداً إلى الوعي ووجهه المشرق الأصيل: الحرية في المعنى الحقيقي الذي أدركناه. “ومن لا يكون حراً في داخله، فكيف يستطيع أن يدرك حقيقة الحياة، حقيقة الحرية والمسؤولية النابعة منها، حقيقة الرسالة التقدمية الاشتراكية، التي هي مظهر للرسالة الإنسانية في هذا المنعطف من التاريخ… كيف يستطيع أن يحرر الآخرين وهو لا يدرك معنى الحرية“.
والحرية معرفة، فكيف يكون حراً من يجهل معنى الوجود ورسالة الحياة والإنسان، فالمعرفة أداة التطور الأولى وعامله المؤثر الأساس، وهي مفتاح العقل البشري لأبواب الفهم والإدراك والاختبار والعمل، وللقيم والأخلاق وللشرائع والأنظمة.
إن النظام الذي تراه التقدمية الاشتراكية هو نظام العقل بالنسبة للجماعة وإن التقدم الذي نريده يدعونا إلى أخذ العقل كمقياس أول تتحدد من خلاله الأحداث والظواهر والأفكار … قبل أن تبرز إلى التحقق.
فالتقدم عندنا لا يعني مجرد المرور من حال إلى حال أو مجرد تغيير الأشياء، وتبديل العادات، وتطوير الأوضاع، وانقراض القديم وارتفاع الجديد في أثره.
ولا يكون التجديد والتمدن والتحضر والتثقف في تقويض كل قديم، ونحن نكاد لا نستوعب عدد الأجيال التي مرت لإبراز ما وصلت إليه البشرية خلال مسيرتها، بل يكون باختبار الأفضل والأصوب والأكثر ملاءمة لطبيعة الإنسان وأغشيته وأعصابه وصحته ولنمو شخصيته ونفسيته وتفتحه وراحته الحقيقية وسعادته. وهذا ما أشار إليه كمال جنبلاط: “إن سلامة العنصر البشري ـ جسداً وحواساً وأغشية وعقلاً وخلقاً وذهنية فاعلة خلاقة ـ أساس لبقاء ونمو الإنسان وتطور الجماعة والمدنية، وإن إحدى وظائف الدولة الأساسية أن تتدبر ما به تحقق المحافظة على سلامة النسل “… وقد وضع لهذا الهدف مبادىء وبرامج ودراسات وخطط لتحقيق بدءاً من العناية الصحية وصولاً إلى الحفاظ على بيئة نظيفة على مستوى الماء والهواء والمحيط والغذاء، مروراً بتنظيم البناء السكني للمدن والقرى، والعودة إلى الطبيعة والأرض…
وفي كل هذا ينطلق من النقطة الجوهرية المحورية في فكره ونهجه وعمله ألا وهي أن الإنسان هو الجوهر والهدف والغاية لكل عمل أو نشاط بشريين .
والإنسان في الحقيقة يسعى لطلب الأفضل على الدوام (حتى ولو ضاع أحياناً في تحديده لما هو أفضل وبالرغم من اختلاف الأنسب والأفضل من إنسان إلى آخر) وهنا يتدخل العقل من جديد بوظيفته الأساسية في التمييز والتدقيق والمقاربة والمقارنة من أجل الاختيار الأنسب والأفضل.
إن العودة إلى المقولة التي طرحها كمال جنبلاط بان الحزب وجهة نظر في الحياة على إطلاقها، والى نظرة الحزب إلى الإنسان كغاية لكل عمل ومؤسسة بشريين، تطرح حكماً التساؤل العادل حول دور التقدمية في المسيرة العملية للتطور أي المسيرة الاجتماعية والاقتصادية وانعكاس هذه النظرة الشاملة على الإنسان والمجتمع والوجود.
وفي هذا المعنى، فإن الوجه الآخر للتقدمية يتمثل بأنها تعبير عصري عن واقع حركة التاريخ وهي في خط مواجهة مباشر بين قوى التحرر والتقدم والعلم من جهة وبين قوى العبودية والجهل والتخلف والاستعمار من جهة أخرى. فإذا كانت التقدمية، موقفاً علمياً ـ فلسفياً، فهي من الجهة الثانية موقف سياسي، إجتماعي، ثقافي شامل يجد في الاشتراكية العلمية الإنسانية ترجمته الصحيحة. وهذا يقودنا إلى ضرورة البحث التفصيلي في مفهوم الاشتراكية والإنسان والسياسة مما يتطلب دراسات جديدة سنعود إليها مفصلة في مواضيع أخرى.
على أن نفهم جلياً أساساً متيناً من أسس التقدمية وهو الانفتاح وعدم الوقوع في فخ التقوقع والصنمية وعبادة الأفكار الجامدة، فإذا كان الصنم المادي ثعباناً، كما يقال، فإن الصنم الفكري هو تنين. و”إذا كانت النتيجة من تأليف الأحزاب والجمعيات ونشر المبادىء ـ ومنها الدينية ذاتها ـ جعل المواطن الإنسان مرتهناً في ما يفكر وفي ما يشعر وفي ما يتصرف، بتفكير غيره وبشعور غيره وبتصرف غيره، ومرتهناً للأيدولوجيا، فتكون الأحزاب والجمعيات، وحتى الأديان، تزيد في تقييد الإنسان، في ارتهانه، في جعله يسلم حريته للآخرين بلا وعي وبلا تمييز وبلا محاكمة“. وفي ذلك لون من التزلم للفكر والعقيدة والشريعة الدينية، كذاك اللون الآخر من التزلم للزعامات والأفراد أي للارتهان والمعبودية.
هكذا نفهم التطور وهكذا نفهم التقدمية وهذا هو مفهومنا للحزب ودوره ليكون أداة لتحرير الإنسان، “ولذا نشدد على التعمق الدائب في الفكرة، في القضية والابتعاد ما أمكن عن التحمس السطحي والمزايدة، وعلى تكوين الشخصية لا على شحن المعلومات“.
“يستطيع الناس أن يركضوا، وأن يلهثوا وراء أصنامهم ما شاؤوا وأن يلحقوا ببعض الجماعات المضلّلة والأنبياء الجدد المضلّلين، ولكننا نسير على مهل، ولا نلبث أن نراهم عادوا على أقدامهم الرجعى، وانضم بعضهم إلى قافلة المسيرة الثابتة…”
أمسك يا أخي معولك وأبدأ في الهدم، إن كنت قادراً على التمييز بين ما يجب أن يبقى من تقليد أبرزه التطور واكتسب صفة الحقيقة، وبين ما يجب أن نرفضه…. أمسك يا أخي معولك إن كنت تعرف ماذا ستبني من جديد لا من خيالك، بل من حاجات الناس ـ مجموع الناس ـ ومن منطلق شرعة الجدلية في جيلك وعصرك، وفي متوجبات تفتح الإنسان على قيمه، لأن الإنسان هو الذي أنشأ الحضارة وأنشأ القيم وأبرزها، فيجب أن نعود إليه دائماً كقياس لكل ما نعمل.
—————————-
(*) قيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي
(**) نشرت في مجلة الفكر التقدمي العدد 22
 عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال
عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال
 صحافيون أم عرّافون!
صحافيون أم عرّافون!
 ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟
ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟


 عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!
عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!
 “الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط
“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط
 هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط
هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط
 طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST
طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST
 عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول
عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول
 عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!
عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

 Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead
Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead
 “Not Enough!”
“Not Enough!”
 … لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا
… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا
 كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني
كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني
 رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل
رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل
 التوازن السياسي في لبنان
التوازن السياسي في لبنان
 لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة
لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة
 جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك
جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك
 Le Liban est un symbole de tolérance
Le Liban est un symbole de tolérance
 Our Automated Future
Our Automated Future
 The True Origins of ISIS
The True Origins of ISIS
 Les Misérables vs. Macron
Les Misérables vs. Macron
 عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان
عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان
 رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم
رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم
 إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي
إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي
 أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018
أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018














